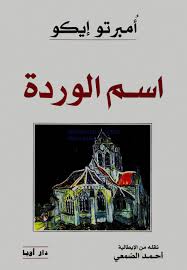«إسم الوردة» لايكو والشراكة بين السيمائية والتفكيكية
بقلم علي مهدي زيتون
تمهيد :
تبدأ هذه القراءة بطُرفة ممهّدة تليها مجموعة من النقاط المتدرّجة في معالجة الموضوع : السيمائية، التفكيكية، من التنظير إلى الرواية، التمهيد درس في السيمائية، «اسم الوردة» والشراكة، «اسم الوردة» بين التاريخ والوظيفة .
طُرفة ممهّدة:
لم تخطر الفائدة ببال الأحفاد مطلقاً، عندما طلبوا من جدّهم أن يقصّ لهم (حكاية) . كان همّهم الأوّل والأخير المتعة المترتبة على تلك الحكاية . فالحكاية عندهم هي المتعة. وعندما شرع الجدّ بالحكاية، وفق البدء التقليدي بـ«كان يا ما كان، كان في قديم الزمان»، أصغى الأحفاد بانتباه لافت، وأمّلوا النفوس بما يسّر . وعندما انتقل ذلك الجدّ إلى السرد قائلاً: كان لأمير من الأمراء ثلاثة أولاد، وكان يملك قطيعاً من النعاج يبلغ الثلاثمئة . أمل الأحفاد خيراً، ولكنّهم فوجئوا عندما طلب الجدّ منهم أن يحسبوا حصّة كلّ ولد بعد أن قسّم الأبُ القطيع عليهم . راحوا يحسبون بتململ شديد، عندما فاجأهم بالسؤال الثاني : كم يصير لكلّ ولد لو انتجت كلّ نعجة توأمين ؟ وتناسلت العمليات الحسابيّة إلى أن ضجر الأولاد وانفضوا من حول جدّهم الذي كان يريد من الأسئلة الحسابيّة تمهيداً لحكاية معقّدة تنمّي تفكير الأحفاد ، وسلوكهم ، وتضيء أمامهم قيماً أخلاقيّة رفيعة .
قراءة الرواية وتجهيزها :
حضرت هذه الحكاية في ذهني وأنا أقرأ رواية «اسم الوردة» حكاية امبرتو إيكو للأحفاد الآتين . تفاجئك صفحاتها الأولى بدرس مستصعب في السيمائية، فتسأل نفسك : بم يجب أن يتسلّح القارئ من علوم ومعارف قبل الولوج إلى عالم هذه الرواية ؟ السيمائيّة حاضرة بقوّة لا يكاد يخلو منها سطر من سطور الرواية التي بلغت خمسمئة واثنتين وسبعين صفحة كبيرة طُبعت بحرف دقيق . والتفكيكية هي الأخرى واكبت السيمائيّة ، وأحصت عليها أنفاسها، خصوصاً عندما استحضرت التاريخ مادة عبر ثنائيّة (الماضي/الحاضر) التي يتعالى فيها الماضي ويتحكم في سيرورة الحاضر وتشكّله ، واستحضرت نظريّة التلقّي في صيغتها المتطرّفة التي تقول بأن القارئ هو الذي يعطي النصّ ما يقوله .
وإذا كان الوقوف عند السيمائية مدعاة للوقوف عند علم اللغة والحداثة ، فان الوقوف عند ما بعد الحداثة (التفكيكية)، وقوّة حضور الماضي، ونظريّة التلقي مدعاة للوقوف عند محاولة صمود تلك الحداثة في مواجهة الحرب التقويضيّة التي ووجهت بها . ويصل بنا هذا إلى سؤال مبدئيّ: «إسم الوردة» لمن كُتِبت ؟ وهل يكون بإمكان قارئ غير متضلّع بالحداثة وبما بعدها أن يخوض غمارها ، وأن يخرج منها بصيدٍ يتعدّى الفائدة إلى المتعة ؟
1ـ السيمائية : السيمائيّة علم حداثيّ المنشأ وردت الإشارة الأولى إليه في الثقافة الغربيّة من خلال الدروس التي ألقاها سوسير على طلابه بين العامين1906 و1911، والتي جُمعت ونُسّقت في الكتاب الموسوم بعنوان «مبادئ اللسانيّة العامة» الذي تنبأ سوسّير فيه ، بظهور هذا العلم ، وأعلن أن اللسانيّة ستكون جزءاً منه . وتكمن حداثيّة هذا العلم في انتمائه إلى زخم العقل العلميّ الذي توخّى اليقينيّة التي مثلت ميسم الحداثة الذي أعطاها هويّتها . وإذا خالف بارت سوسير ، مقلّلاً من أهميّة أيّة أنظمة سيمائيّة مستقلّة عن اللغة ، وحاسباً السيمائية جزءاً من اللسانيّة لا العكس، فان هذا العلم ، وبقطع النظر عن جذر عربي مكين له خصوصاً في «تمهيد» الشهيد الثاني، قد ازدهر ازدهاراً قويّاً في الغرب الحداثي ، وبات له مدارس وتوجهات متعدّدة . وإذا كان امبرتو ايكو من المشتغلين الأساسيين في هذا العلم، فانّ تأهيله ، على يديه، للعمل في مناخات ما بعد الحداثة وأجوائها، لم يكن ليعبّر عن المستوى العالي الذي وصلته شخصيّة ايكو الثقافية ، فحسب، ولكنّه عبّر عن قدره هذا العلم على اختراق الاتجاهات الثقافية المستجدّة، والتأقلم مع مناخاتها ليصبح وكأنه زرع من زروعها .
2ـ ما بعد الحداثة (التفكيكية): لعل السؤال الأوّل المحرج الذي يواجهنا ونحن نستطلع هذا العنوان (التفكيكيّة) هو: كيف لنا أن نفهم مصطلحاً هدفه الأساسي تقويض المفهمة (Conceptuaslisation) ؟ فمصطلح ما بعد الحداثة (Postmodérnisme) يعني أول ما يعنيه سقوط الحداثة والبنيويّة . وسقوطهما يعني سقوط ما يمثلانه من إمامة العقل، والتماسك ، وسيادة المفهمة التي يمكنها أن تأخذ بيدنا خطوة خطوة إلى مأمننا الوثوقي . ويعني هذا أنّنا سنسلم أنفسنا للتيه بكلّ ما تعنيه كلمة التيه من معنى . ويصبح الهدف الأوّل، بناء على ذلك ، تقويض فلسفة الحضور وإحلال فلسفة الغياب محلها، غياب قصدية المؤلف عن نصّه ، وغياب الذات عن الإنسان .
ويستتبع هذا الغياب غياباً لأي مركز، ولأية مرجعيّة . عالم ما بعد الحداثة ليس نظاماً . هو مجموعة من النظم الصغيرة المفكّكة المغلقة على نفسها. هو عالم غير متماسك، كيف لا، والتفكيكيّة فلسفة هدفها تقويض المينافيزياء الغربيّة السائدة؟ والميتافيزياء الغربيّة السائدة بالنسبة إلى التفكيكيين (إمامة العقل وسلطانه وحاكميّته) . وتقويض مركزيّة العقل (Logocentrisme) يعني رفضا قويّا للمشروع الحداثي الغربي الذي يرى أن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره ، وأن العقل وحده قادر على الوصول إلى تفسير كليّ شامل لهذا العالم . والثقة المتناهية بالعقل تؤدّي حتماً إلى الأعتقاد بأنّ الوجود حضور. ويعني أنّ ما تصبو إليه التفكيكيّة هو فهم مختلف لوضعيّة الإنسان في هذا العالم . لا يعيده إلى زمن الخرافة ، والخرافة عامل استقرار تعويضي ، ولكنه يرسل به إلى فضاء من التشتت ، مرعبٍ لا يستطيع الاستعانة فيه لا بالخرافة ولا بالعقل .
ويُعدّ ايما نويل كانت (1724 _ 1804) من المؤسّسين الأوائل للتفكيكيّة في نقده الموجّه إلى (العقل الخالص) الذي رأى فيه أن العقل (خالصاً) عاجز عن الوصول إلى حقيقة ما يقينية .
وجاء نيتشيه (1844 ـ 1900) الذي رأى أنّ العقل ليس المرجع الصالح لتحديد الخطأ من الصواب ، وأنّ الحقيقة مجرّد وجهة نظر ، ووجهة نظر القويّ على وجه التحديد ، فاتحاً الباب واسعاً أمام العدميّة . وكرّت السبحة إلى أن وصلنا إلى جاك دريدا الذي دفع باب العدميّة إلى نهاياته، جاعلاً من التفكيكيّة فلسفة بديلة في مواجهة مركزيّة العقل والحضور .
وتتصل الاستراتيجيّة التفكيكيّة بنظريّة التلقّي المتطرّفة بغير آصرة . فالقراءة ، ما بعد الحداثيّة ، هي نقلٌ لسلطة التفسير من النصّ وقصد المؤلف إلى القارئ المتلقي . فالنّص ، بالنسبة إلى هذا التوجّه ، غير قادر على أن يقول شيئاً . والمؤلّف لا يملك فيه أيّة قصديّة محدّدة . فهو غياب مفسح في المجال أمام النصوص التاريخية السابقة لتتزاحم فوق ساحته وتأخذ حيّزها الكامل فيه . وهذا ما يوصل إلى أن القارئ لن يجد في هذا النصّ إلاّ ما حمله هو إليه من معنى .
وهذا مدعاة لكي يستبعد القارئ التفكيكي عن دائرة اهتماماته كلّ ما يمكن أن يتراءى للقراءة غير التفكيكيه بأنّ النصّ قد قاله. يستبعد ، أكثر من ذلك، أن يكون النصّ متطابقاً مع ذاته مرتداً إلى مقولاته . وهو، على العكس من ذلك يستخدم مقولات النصّ التي تدّعي الثبات والانسجام من أجل الكشف عمّا أسماه: المقصيّ ، والمغيّب، والمخفي ، والمطمور ، والمسكوت عنه، وغير الملحوظ من قبل الكاتب .
والحقيقة أن المقصيّ المغيّب، المخفي، المطمور، المسكوت عنه ليس سوى الآخر ، حضور الآخر في النّصّ عبر عملية التناصّ؛ لأنّ الذات عند التفكيكيين غيابٌ وهي مجرّد آثار لكلّ الشيفرات التي تكوّنها([1]) . وهذا يعني أن التفكيكية استراتيجيّة تأويليّة أولاً وقبل كل شيء .
3ـ من التنظير السيمائي إلى الرواية: عُرِف ايكو على الساحة الثقافيّة العالميّة فيلسوف لغة، وسيمائيّاً، ورجل إعلام ، ومفكراً في مظاهر الحداثة، وأمور ما بعد الحداثة . ولعلّ أهمّ نتاجاته النظريّة التي سبقت رواية «اسم الوردة » 1980، هي : «الأثر المفتوح»، و«دراسة في السيمائيّة العامة» 1975، و«القارئ في الحكاية» 1979 . ومما يجدر ذكره، في هذا المقام، أن أهمّ القضايا التي أثارها في نتاجه النظريّ هذا، هو أن العمل الفنّي يملك قابليّة لتعدّد القراءات اعتماداً على مفاتيح تأويلية مختلفة ، وأنّ العلامة هي الأداة التي تمكّننا من فهم العالم ، ومن التعبير عنه بصور متعدّدة ، وأنّ علاقة القارئ بالنصّ السردي رحلة تتطلّب مجهوداً تأويلياً ، ومعرفة موسوعيّة حتى تحصل له المتعة التي يعد بها كل عمل فنيَّ قارئه([2]) . أضف إلى كلّ ذلك أن الانتقال من النظير (نتاجه النظري) إلى السرد (رواية «اسم الورده») لا يمثّل قطيعة ، ولكنّه يمثّل اتصالاً قوياً وتكاملاً . وقول ايكو : «ما لا يمكن تنظيره ينبغي سرده»([3]) هو إشارة إلى تواصل الخطاب الايكوي،بشقّيه التنظيري والسردي، بطريقة أخرى .
كانت الرواية، عند ايكو، امتدادا للتأمّل الفكري بقدر ما وجد التأمل الفكري مخبره في الرواية([4]) . ويعني ذلك أن رواية «اسم الورده» إنما تواصل تحت قناع السرديّة خطاباً نظرياً في فلسفة اللغة والعلامة والتأويل([5]) . وتلفت مجازية (القناع) إلى حقيقة محيّرة . يستخدم القناع ، بوصفه أداة ، مجرّد أداة، لاخفاء المهمّ، ولاغراء الباحث بالتنقيب عن ذلك المهمّ الذي يخفيه ذلك القناع . واغوائيّة القناع واغرائيّته لا تصنفه أساساً ، هامشاً لمتن هو الأصل . فهل صارت الأدبية، مع ما بعد الحداثة، ثوباً مستعاراً لا يملك من الأصالة ما يصنّفها على قدم المساواة مع المضمون ، أو على الأقل أن يكونا وجهين لحقيقة واحدة .
والتقليل من الأدبية ليس القضيّة الوحيدة التي يواجهها القارئ مع رواية ايكو، فالجانب التنظيري المتخفي وراء قناع السرد يضعنا أمام حقيقة مفادها أن ايكو في روايته هذه لا يتقبّل قارئاً كسولاً غير مثقف . أراد لروايته قارئاً مشاركاً من طراز غير عاديّ .
4ـ تمهيد الرواية درس في السيمائية: مهّد ايكو لروايته ، بعد أن حدّثنا عن المخطوط الذي أسس للرواية وعن مدى يقينية ما جاء فيه([6]) ، بمزيج نظري سرديّ وصفي([7]) . قدّم فيه الأساس السيمائي الذي ستقوم عليه رواية «اسم الوردة» . وأوّل ما يلفت في هذا التمهيد وقوفه عند الكيفية التي يتجلى العالم من خلالها ، بالنسبة إلى الإنسان، أو قل : الكيفية التي يعي الإنسان من خلالها العالم . يقول: «نرى العالم من خلال صور ورموز . والحقيقة قبل أن تتجلى لنا كاملة تتكشّف من خلال لمحات (غامضة جداً للأسف)… وعلينا أن نهجّي دلالاتها الوفيّة حتى عندما تبدو غامضة»([8]) . وتأتي إشارة ايكو هذه اعتراضاً على ما بدأ به تمهيده هذا : «في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله»([9]) . فاستدراك إيكو بـ(لكن): «ولكننا الآن، نرى العالم…» هو رفض لمقولة مفادها أنّ اللغة هي الوسيلة الأساسيّة للتواصل ولوعي العالم . وهو بهذا لا يردّ على الكلام الانجيلي المقدّس الذي استُحْضِر ؛ لأنّ المتكلّم راهب، ولكنّه يردّ على ما جاءت به حركة الحداثة التي لا تتمكّن الرواية من ذكرها ؛ لأنّ احداثها تدور في القرن الرابع عشر الميلادي .
كان الكلام الإنجيلي قناعاً لمقولة حداثيّة من أننا باللغة نعي العالم ونتملكه . ويعني ايكو بذلك ان امتلاك العالم باللغة هو امتلاك سطحيّ عام بعيداً عن خصوصيات أشياء العالم ودقائق تمظهرها . ونحن لا نرى حقيقة العالم باللغة ، نرى حقيقته من خلال الصور والرموز (العلامات) . هذه العلامات التي لا تقدّم أسرارها بيسر وعفويّة .لأنّ تلك الأسرار تتكشّف من خلال لمحات ، مع ما تعنيه (اللمحة) من انخطاف يحول دون التحقق . هذا إذا كانت اللمحة لمحة مجرّدة من أية صفة . فكيف إذا أضيفت إلى اللمحة صفة الغامضة ، والغامضة جداً. يتطلّب الأمر جهداً ، تهجئة، أي (تعاملا تدقيقيّاً) مع العلامات من أجل الامساك بحقيقتها الوفيّة ، على حدّ تعبير ايكو نفسه .
ولعلّ أهمّ ما نصل إليه معه هو أنّ العلامات السيمائيّة ليست شريكة للعلامات اللسانية في وعي العالم ونجاح التواصل البشري فحسب ، ولكنها متعالية على تلك اللسانية تعالياً حاسماً .
فاللغة هي اليقينيّة الساذجة ، والنظام العلامي السيمائي هو السبيل الذي يجعلنا ندرك أن الحقيقة ليست بنية جاهزة يمكن القبض عليها عن طريق اللغه . انها بنية مراوغة إذا لم نقل أنها عصيّة بشكل نهائي على التملّك بما يثير شكوكاً، عند التفكيكيين ، بأنه لا وجود لحقيقة ثابته . كل هذا، بقطع النظر عن السجال السوسيري _ البارتي حول الجزئيّة أو الكليّة .
ولا يقيم ايكو مواجهة بين السيمائيّة واللسانيّة فحسب، ولكنه يقيم سجالاً من نوع آخر بين السيمائيّة والعقل .
تحدّث على لسان أدسو راويه في «اسم الوردة» قائلاً : «لقد علّموني في النظام الرهباني الذي أنتمي إليه طريقة مختلفة تماماً لتوزيع وقتي . وقلت له [غوليالمو استاذ ادسو] ذلك، فأجاب أنّ جمال الكون لا يتأتى فقط من الوحدة في التنوّع، ولكن أيضاً من التنوّع في الوحدة. وبدا لي جواباً أملاه مبدأ تجريبي لا يستند إلى المعرفة، ولكنني عرفت فيما بعد أن أهل بلاده غالباً ما كانوا يعرفون الأشياء بطرق يبدو أن دور العقل النيّر فيها ضعيف جداً»([10]) . ولئن ساوى هذا الكلام بين الوحدة والتنوع فان المساواة هنا، هي في المحصّلة ، تقليل من دور الوحدة (البنية) وأهميتها، من جهة، ولفت الإنتباه إلى أهميّة الجزئيات من جهة أخرى ، حتى لكأنه يقول لنا : إن الفتات ذات قيمة يجب أن تأخذ بالحسبان . فهي علامة جمال مثلها مثل الوحدة (البنية) . وإذا ما قاد جواب الأستاذ تلميذَه أدسو، لكي يستنتج انّ هذا الجواب ناجم عن «مبدأ تجريبي لا يستند إلى المعرفة»، فان هذا الاستنتاج يفيد أنّ التجريب، ملاحقة العلامات وما تقدّمه من دلالات يوصلنا إلى أن هذه الدلالات هي حقائق تفرض نفسها بشكل مستقل عن المعرفة التي ينتجها الجهد العقلي عبر التفكير . وفي هذا ايماءة واضحة إلى تعالي السيمائية على العقل . ولا يقلّل من قيمة هذا الاستنتاج نسبة هذا التعالي إلى قوم غوليالمو دون سواهم، حين وصفهم بأنهم لا يقيمون دوراً للعقل . ووصف هذا الدور بأنه ضعيف وضعيف جداً هو إشارة إلى براغماتيّة قوم غوليالمو الذين تتعالى عندهم التجارب ذات الطابع الجزئي على المبادئ . فهل يمثل هؤلاء القوم قناعاً يمرّر ايكو من خلاله ما أراد أن يبثّه من مناخات تفكيكية ما بعد حداثية .
ومهما يكن من أمر، فان ايكو لا يكتفي بهذا القدر من وضع القارئ في أجواء ما بعد الحداثة، وتهاوي كلّ من النظام والبنية . تجاوز ذلك إلى التشكيك بحقيقة الدلالة التي يمكن أن تقدّمها العلامة لقارئها . وذلك تمهيداً للانحدار اتجاه المتاهة .
قال أدسو: «لأنني حضرت أحداثاً يجدر أن تبلّغ إلى ذاكرة من سيأتون بعدي، وهو ما أفضله حالياً [التدوين]»([11]) . يرى أدسو إذا ، أنّ الأحداث التي حضرها في مطلع شبابه هي من الأهمية بمكان يجعلها جديرة بأن تبلّغ إلى من سيأتون بعده .
وما كانت هذه الأحداث لتكلّف أدسو مشقة التدوين لو لم ير فيها دروساً مفيدة يجب أن تخلّص من بئر النسيان؛ لكي لا تعيد البشريّة التجربة نفسها وتقع في الخطأ نفسه . وهو حين أراد إيصالها إلى ذاكرة الآتين لا إلى عقولهم ، إنما أراد لها أن تستمر في اختراق الزمان، وأن تكون عظة مستمرة الحضور. والعظة ، على كلّ حال ، تمثّل خروجاً عن سكة ما بعد الحداثة التي عمر بها تمهيد الرواية حتى الآن ؛ لأن العظة مادّة يتدبّرها العقل دون سواه . فهل خرج ايكو عن رؤيته إلى العالم ؟ لعلّه ترك لأدسو بعض الخصوصيّة ، فلا يكون نسخة طبق الأصل عن أستاذه غوليالمو الذي يمثل ايكو تمثيلاً قوياً ، أو لعلّه أراد أن يسوّغ ، بطريقة ذكيّة ، جدوى عودته هو إلى القرون الوسطى، وإلى حياة الدير فيها ليقدّمها إلينا رواية تُقرأ . ويعود أدسو إلى الاقتراب ، بشكل واضح، من استاذه حين تحدّث عن فلسفته الخاصة المتعلقة بعمله الإجرائي في تدوين سيرورة تلك الأحداث . «ها أنا أتهيّأ لأن أترك على هذا الرقّ بيّنة على الأحداث المدهشة والرهيبة التي عشتها وأنا شاب، معيداً بالحرف والكلمة ما شاهدت وما سمعت، دون المجازفة بأي حكم أو استنتاج ، كمن يترك للقادمين … علاماتٍ لعلامات كي تتمرّس عليها عبادة فكّ الرموز»([12]) . ثم يُردف قائلاً : «ليجعلني الربّ بفضله شاهداً شفافاً على أحداث وقعت في دير من الأفضل والأرحم ألا أذكر اسمه»([13]) . إن وصف ما تركه أدسو على الرق بأنه (بيّنة) يضعنا في مناخ حقوقيّ واثق من نفسه ومن النتائج التي يمكن أن تُبنى عليها . وإذا ذكّرنا هذا بالحداثة وبما يقتضيه العقل العلمي من حقائق يقينية ، وضعنا قولُهُ : «معيداً بالحرف والكلمة» ووصفّه نفسه بالشاهد الشفاف في دائرة ما قبل الحداثة التي ترتكز إلى نظرية الانعكاس في النقد الأدبي . فالإعادة بالحرف والكلمة لما شاهد وسمع هي إشارة إلى الدقة في العمليّة النسخية، وشفافية شهادته هي الأخرى مؤشر واضح إلى منهجية التصوير الفوتوغرافي . وكلتا الحالين، وان مثّلتا خطوة إلى الوراء داخل النظرية النقديّة، إلاّ أنهما توحيان بأن ايكو قد أراد لأدسو أن ينقل إلينا ما شاهد وما سمع بوصفها مجموعة من العلامات الدالة ، وليسا تاريخاً ، وحقائق تاريخية .
وهذا ما يخرجه من دائرة الاحتكام إلى العقل والتفكير ليدخله دائرة التجريب المفتوح على وقائع متجاورة من دون أن تمثل بنية أو ترتكز إلى نظام ، خصوصاً أنه قد وصف أي حكم أو استنتاج يطلقه أدسو تعليقاً على تلك الأحداث هو مجازفة ، والمجازفة محفوفة بالمخاطر، تقف فيها إمكانات النجاح إلى جانب إمكانات الفشل ، والنجاح أو الفشل كلاهما مرتبط بحقيقة الدلالة المحتملة . وإذا كان أدسو الذي واكب تلك الأحداث لا يسمح لنفسه بالمجازفة في الحكم أو بناء الاستنتاج عنها ، فهل ينتظر ، منّا نحن ، بعد ستة قرون أن نجازف بالحكم والاستنتاج ؟ هل أراد ايكو من كل ذلك أن يقول بأن عبادة الإنسان المعاصر ، هي «تمرّس في فك الرموز»؟ وما التاريخ المكتوب سوى (علامات لعلامات) ، تتطلب قراءة مركبة ليست سهلة المنال . إذا أعدنا هذا الكلام إلى زمن أدسو ، القرن الرابع عشر ، فانه يمثّل نبوءة بالتفكيكية ، وإذا أعدناه إلى زمن أيكو فانه يمثّل وصفاً لحال الثقافة هذه الأيام . وما نسمعه من تعليقات أو تحليلات لأيّ حدث لافت هذه الأيّام لم يعد سعيا إلى الحقيقة ، إذا لم نقل أنه لا يضع الحقيقة مطلقاً في حساباته، صار عبادة وثنيّة لفك رموزيّة الحدث وفقاً لأهواء اللات أو هبل من دون الاصغاء إلى صوت العقل الذي تتمسّك به قلّة من المؤمنين بالعلميّة منهجا، ومن المنتظرين الحقيقيّين .
ولقد دفع هذا أدسو ، سارد الرواية ، إلى استخدام فعل (أخمّن) حين أراد الكشف عن حقيقة معرفة غوليالمو بما يبحث عنه . وبقطع النظر عن تخمين أدسو التشكيكي ، فانّ ما يقوم به غوليالمو مدعاة للشك بسبب غموضه . فلو كان واضحاً لما ارتكز قول أدسو على التخمين ، خصوصاً أن غوليالمو نفسه كان شكّاكاً . يقول لنا أدسو: «والشكّ ـ الذي كان دائماً يبديه [غوليالمو] ـ بأن الحقيقة ليست تلك التي تظهر له في الآونة الحاضرة»([14]) . ويصلنا قوله «بأن الحقيقة ليست تلك التي تظهر له في الآونة الحاضرة» بمصطلح (الأرجاء differance) التفكيكي . ويعني هذا أن الحقيقة التي تظهر في الآونة الحاضرة هي أثر لأصل . لا الأصل ثابت ولا الأثر ثابت . وهذا ما ينفي ثبوتية الحقيقة على حال . فهي معلقة بالأرجاء الذي لا يستقرّ على حال . ويضعنا مصطلح (الأرجاء) أمام مصطلح آخر هو الملحق (supplement) الذي يقوم على سلسلة من التغييب لا تنتهي ، تغييب الأصل(2) وهذا ما يقدّم لنا مصطلح (الارجاء) تقديماً جيداً ومفيداً .
ويبقى أنّ (الارجاء) الدريدي قائم على أنّ حضور معنى العلامة غير قابل للتحقّق . وذلك لأن كل ّ إشارة تحيل، بلا انقطاع ، إلى الدلالات السابقة (أصول الأصول) . واللاحقة (آثار الآثار) محدثة تفتتاً لحضور المعنى ولتماثله . ولن يكون المعنى حاضراً أبداً ؛ لأنه قد بات مرجأ(3) .
ويأتي شكّ غوليالمو بالحقيقة المتمرئية له في الآونة الحاضرة إشارة إلى التحوّل المستمرّ الذي يحكم دلالة أية علامة ، ويجعلنا نسأل عن يقينيّة الحقيقة التي قد تظهر غداً. والغد ألن يكون في لحظة ما آونة حاضرة ؟ إننا أمام سيمائيّة تفكيكيّة يتعامل معها ايكو ، أو قل إننا أمام التأويلية الدريديّة .
وتصيب العدوى أدسو . فهو في تقديم أستاذه غوليالمو كان يمارس قراءة العلامات المتمثلة في أقواله وسلوكه ومواقفه ، فيرى نفسه «كمن يجمّع منذ البداية الانطباعات المتفككة التي أوحى إليّ بها آنذاك([15])» . وأوّل ما يشير إليه هذا الكلام أن شخصيّة أستاذه قولاً وسلوكاً ومواقف لا تمثل بنية متماسكة ولا يضبطها انتظام محدّد . ما تركته تلك الشخصيّة ، في ذهن تلميذه ، انطباعات متفككة من دون أية لحمة توحّد بينها . والانطباع على كل حال ، قراءة ضمنية لعلامة ، بقطع النظر عن طبيعة هذه العلامة كلاماً كانت أم سلوكاً أم موقفاً . وأن تكون دلالة هذه العلامات انطباعات يعني أنها دلالات غائمة. وإذا أضفنا إلى هذه الضبابية التي تكتنف هذه الدلالات ، بأنها دلالات متفككة يعني أنها لا تخضع لأي ناظم ينظمها . ويذكرنا هذا بمصطلح البعثرة التفكيكي (dissémination) . والبعثرة تنافي مفهوم المركز الواحد الي ترى فيه الثقافة الحداثية البنيان الوطيد الذي ترتكز إليه السرديّات الكبرى (الأيديولوجيات والنظريات المتماسكة) . وعندما كسر دريدا المركزية المعنوية ورأى أنها مراكز عديدة ، غاب المعنى وتحوّل إلى صيرورة لا تستقرّ عند مآل . وهذه الصيرورة تعني بعثرة معنى دالّ العلامة إلى ما لا يحصى ولا يعد([16]) . وتصبّ هذه البعثرة في مجرى نقل السيمائية من انتمائها الحداثي إلى دائرة ما بعد الحداثة . فهل يعني ذلك أن السيمائيّة الايكويّة هي سيمائيّة عدميّة خالصة ؟
يطالعنا تمهيد الرواية بإشارة تجعلنا ندقّق في الحسابات ، وفي استخلاص النتائج . ينبئنا أدسو بأنه بقي يجهل المهمّة التي عُهد بها إلى أستاذه طوال سفرهما . ولكنه بعد الاستماع إلى بعض محادثاته مع رؤساء الأديرة التي توقفا فيها خلال سفرتهما تكوّنت له «فكرة عن طبيعة المهمّة التي كان يقوم بها» . ومع ذلك فانه لم يفهم ذلك تماماً إلاّ عندما وصلا إلى نهاية مطافهما «كما سيأتي ذكره»([17]) . فهل يعني هذا الكلام أنّ الانطباعات المتفككة التي حصّلها أدسو عن غوليالمو مترابطة من خلال خيط ناظم لها لم يمسك به أدسو ولم يدرك وجوده في بداية الأمر، لحداثة تجربته وصغر سنه ، وان كان هذا الخيط موجودا في الحقيقة والواقع ، خصوصاً كما ذكر في «ورقة أخيرة» من روايته ؟ قد تكون سيمائيّة ايكو سيمائيّة غير مُخَلّصة تماماً من انتمائها إلى الحداثة (العقل العلمي اليقيني)، وهي قد أفادت من الأسئلة التي طرحتها ما بعد الحداثة (تقويض مركزية العقل) إفادة لم تدخلها دائرة العدميّة ، خصوصاً أنّ الرواية بمجملها قد لا تنتمي إلى أدب ما الحداثة ؛ وان كانت ترى في الحداثة شيئاً من السذاجة والاستعجال في الاستنتاج والقراءة أراد إيكو تخليصها منها .
5ـ «اسم الوردة» بين السيمائيّة والتفكيك: تكشف قراءة الرواية أنْ ما يزيد على المئتي إشارة كانت على علاقة واضحة وقويّة بالسيمائية : تنظيراً ، أو قراءة لعلامات ، أو تشكيكاً بنجاح قراءة ، وهذا الرقم رقم غير عادي يقدّم انطباعاً لدى القاريء انه في مواجهة رواية مختلفة تتجاوز المقولة النقديّة التي تفيد بأن (الرواية نظام سيمولوجي) وما يعنيه ذلك من أنّ أيّ بعد سرديّ أو وصفيّ في أيّة رواية هو علامات متواشجة تضبطها رؤية الروائي إلى العالم . ولا تفسّر المقولةُ الايكويّة «ما لا يمكن تنظيره ينبغي سرده» اختلاف هذه الرواية عن غيرها تفسيراً ناجحاً ، مع قوّة هذه المقولة وقوّة حضورها في الرواية . ولعلّ هذه الفرادة ناجمة عن وجهة نظر خاصة بايكو في فهم الأدب في ظلال ما بعد الحداثة . والمناخ التشكيكي الفاقع الذي واجهنا به أيكو في الجزء الأول الموسوم بعنوان «مخطوط بطبيعة الحال» من روايته حيث وجدنا فيه ثلاث عشرة إشارة تشكيكية تتعلّق بصحّة المعلومات أو دقتها ، إنما يترك انطباعاً لدى القارئ أنه أمام أسوار رواية صعبة المراس .فهو،من جهة، فريسة علاقاتٍ دالُّها مراوغ يجعل من مدلوله ذاكَ دالّا جديداً يشير إلى مدلول مختلف يتحوّل كلّ مرّة إلى دالٍ ، وإلى ما لا نهاية بما ينسف وحدة طرفي العلامة ،وهو ،من جهة أخرى، فريسة علامات وجودها غير محسوم . وقد لا تكون موجودة . ويمثّل هذا إشارة إلى القارئ لكي يتفقّد إمكاناته وأدواته وعدّته التي جهّزها لقراءة هذه الرواية .
1.5ـ علامات دالّة: لا ينفي هذا المناخ الذي واجه به ايكو قارئه وجود علامات دالّة . ذلك أنّ هذه الرواية كثيراً ما تجعل القارئ يركن إلى بعض العلامات بوصفها علامات حاسمة في دلالتها ، واثقة من قوّة حضورها وجلائها . فالسؤال الذي وجهه غوليالمو للراهب برينغاريو ، في أثناء التحقيق عن مقتل الراهب الشاب الوسيم ادالمو : «ولكن قل لي ، كيف رأيت وجهه الشاحب ان كان الليل حالكاً ؟ وكيف أحرق عرقه يدك إن كانت ليلة مطر وبرد وثلج ؟ وماذا كنت تفعل في المقبرة؟»([18]) . هذا السؤال يحمل من السيمائية ما يحمل . فالليل وان سمح بمعرفة شكل الوجه، فانه لا يسمح وهو حالك، برؤية ما اعترى ذلك الوجه من شحوب . والكلمتان : (شاحب) و(حالك) لا تحملان علاميّة كذِب برينغاريو فحسب، ولكنهما تومئان إلى استخدام المنطق والعقل في قراءة العلامة المتمثلة بكلام برينغاريو، استخدام العقل في تقدير الأمور وفهمها. ولا تقلّ القراءة الثانية لعلاميّة كذبه بالسؤال: «كيف أحرق عرقُه يدك في ليلة ، مطر وبرد وثلج؟» . انها هي الأخرى قراءة دقيقة استناداً إلى العقل والمنطق . ويضعنا هذا في مناخ الحداثة في تعاملها مع قراءة العلامات ، فيما يتعلق بيقينيّة الدلالة وعقلانيّتها ، ولئن أشار السؤال الأخير الذي توجّه به إلى برينغاريو : «ماذا كنت تفعل في المقبرة؟» إلى علامات غائبة مرتبطة بحضوره ذاك في تلك الليلة الباردة ، محمّلة بدلالات مفتوحة إذا لم نقل أنها تائهة ، لا يعني أنّ كلّ العلامات هي على هذه الشاكلة .
سأل غوليالمو طبّاخ الدير الذي تحدّث بعصبيّة وتشكيك بمصداقية الراهب سلفاتوري الذي شوهد يهرّب طعاماً للمعّازين من دون إذن: «لماذا قلت في الليل.» «فقام الطباخ بحركة يعني بها أنّه لا يودّ الحديث عن أشياء ينقصها العفّة» فلم يزد غوليالمو في سؤاله»([19]). استنتج غوليالمو دلالتها بوصفها علامة ذات دلالة يقينيّة ، دلالة تعدّت قصديّة الطبّاخ تهريب الطعام إلى الهدف من ذلك التهريب . فهو ليس تهريباً، لوجه الله، يُراد منه اشباع بطونٍ جائعة . هو مقايضة الطعام المهرّب بعلاقات جنسيّة مشبوهة في الدير . ولم تكن هذه (الحركة) العلامة الوحيدة التي تحمل مثل هذه اليقينيّة في دلالتها .
خاطب غوليالمو تلميذه أدسو قائلاً: «لنفترض أنّ شخصاً قُتِل مسموماً يمكنني من خلال التجربة أن أتصوّر … أنّ شخصاً آخر قام بعملية التسميم»([20]) .
ولئن كان الاستنتاج قائماً على (التجربة) لا التفكير العقلي من جهة ، وعلى (التصوّر) من جهة اخرى … والتصور قابع وراء غشاء شفيف يقدّم اليقينيّة يقينيّة غير مكتملة ، لأنه قابل للأخذ والردّ ولا يصل بنا إلى يقينيّة مطلقة، فانّ قوله : «هناك بعض العلامات غير قابلة للجدال»([21]) ، في أثناء حديثه عن عمليّة التسميم، وما تعلّق بها من فرضيّة ، إنما يقدّم تلك العلامة علامة حاسمة في دلالتها . وما يعزّز ذلك أن غوليالمو يقول: «يمكن لفكري ، في نطاق هذا التسلسل البسيط من العلل، أن يعمل وهو واثق شيئاً ما من قدراته»([22]) . فالتقليل البسيط من وثوقيّة عمل فكره من خلال إشارته (شيئاً ما)، لا ينفي إمكانية الارتكاز إلى المنطق والعقل استناداً إلى (التسلسل البسيط من العلل).
ويجرنا هذا إلى أن نرى في ما بعد حداثة ايكو تفكيكيّة غير مخلّصة تماماً من الحداثة . خصوصيّة نظرته إلى الأمور تقيم حواراً ما بين المرحلتين الثقافتين الغربيّتين . ولا يعني ذلك مصالحة ، ولكن إمكانية تعاون في بعض الحدود . وهذا لا ينفي أن يكون العقل مرجعاً، ولو بحدود ، لتحديد الخطأ من الصواب ، من دون أن يصل به الأمر إلى القول بحاكميته المطلقة من جهة ، ولا القول بأنّ الحقيقة هي وجهة نظر مستقلة عن العقل ، أوالقول بأنّها خاضعة ، بشكل كامل ، لمقولاته ومنطقه .
2.5ـ علامات مضلّلة: حضرت إلى جانب العلامة الدالّة ، في هذه الرواية، أنواع من العلامات الأخرى التي يمكن أن نصفها بأنها علامات مضلّلة . ولعلّ أولى تلك العلامات هي تلك التي لا تحمل أيّ معنى . خاطب غوليالمو تلميذه آدسو قائلاً: «لا تنس أنّ هناك أيضاً علامات تبدو كأنها تعني شيئاً ، ولكنها في الحقيقة عديمة المعنى»([23]) . فهل يمكن لصورة أن تكون حياديّة مجانيّة، والعالم حسب ايكو نفسه صور ورموز وظيفتها الأولى أن تشكل دعوة للقراءة ؟
إنّ كلام غوليالمو (ايكو) ليس بهذه السذاجة ، فالعلامة عديمة المعنى هي علامة منهجيّة ، قابليّه «لتعبّر عن قصد آخر»([24]) على حدّ تعبير غوليالمو نفسه . ولئن أشار هذا إلى أمر، فانه يشير إلى دعوة للتعامل مع العلامات خارج دائرة الحداثة واليقينيّة ، وبعيداً من العفويّة . ولئن وُجدت علامات طبيعيّة تقدّم دلالتها بيسر ، فان علامات أخرى ، كتلك التي وُصفت بأنها عديمة المعنى رُكّبت وفق تخطيط مدروس . ويعني ذلك أنها قد استُحضرت بناء على تفكير ، ويعيدنا هذا إلى خصوصيّة ما بعد الحداثة الايكويّة .
ولقد حضرت إلى جانب العلامة عديمة المعنى العلامة الباهتة الدلالة ، ذهب غوليالمو في تحقيقه بالجرائم التي حدثت في الدير مذهباً نظرياً في قراءة العلامات حين قال : «خلال كلّ جريمة تُرتكب للحصول على شيء، تعطينا طبيعة ذلك الشيء، فكرة ، ولو باهتة»([25]) . وغوليالمو بوصفه محققاً، قارئاً للعلامات (الدلائل)، يتوقّف عند الشيء الذي تُرتكب الجريمة للحصول عليه، ويتخذه علامة قابلة للقراءة سعياً وراء الحقيقة اليقينيّة التي هي ضالّة أي محقّق ، وان يصف الفكرة (الدلالة) التي تقدّمها هذه العلامة بأنها (باهتة) ، يعني أنها على مسافة شاقّة من اليقينيّة، وان كانت لا تخلو من أيّة فائدة . فائدة يمكن استثمارها .
ويوضح هذه الحقيقة تلك الافتراضات التي ساقها غوليالمو والمتعلقة بأهميّة ما تركه فينانتسيو «لماذا بذل أشخاص عديدون، وليسوا كلّهم مجانين ، ما في وسعهم، في البداية لاخفاء الكتاب، ثم لاستعادته من جديد ؟»([26]) .
يشير هذا السؤال إلى وجود علامة ضمنيّة (بذل الجهد)،لإخفاء الكتاب حين يكون في اليد، ولاستعادته حين يفلت منها . وهذه العلامة علامة غائمة الدلالة . ونجد مثل هذا في حديثه عن سبب ترك فينانتسيو المخطوط في الدُرج . والاحتمالات التي عدّدها غوليالمو
لذلك السبب هي: «احسّ بوجع»، «سمع أحداً يصعد»، «تمنية النفس بالعودة إليه مساء» ، أضف إلى لك أنه «من طبيعة الكتاب فقط يصبح بالامكان الوصول إلى طبيعة المجرم»([27]) فمعرفة طبيعة الكتاب التي يجهلها المحقق، لا توصله إلى المجرم ، ولكن إلى طبيعة المجرم، طبيعة يمكن أن يتصف بها متعدّدون . فالعلامة بناء على ذلك علامة باهتة تؤشّر ، ولكنها تبقى على مسافة واضحة من الحقيقة اليقينيّة . ويعني ذلك أننا ما زلنا أمام علامة متعدّدة الاحتمالات لا توصلنا إلى برد اليقين .
ويقف غوليالمو عند إلحاح بانشيو على دفعه مع أدسو نحو المكتبة([28]) ، بوصف هذا الالحاح علامة ، فيجدها علامة غير حاسمة في دلالتها . تترجح دلالتها بين أن تكون رغبة بانشيو في أن يكتشف غوليالمو شيئاً في المكتبة يتوق بانشيو إلى معرفته([29]) ، وبين أن يكون دفعهما تجاه المكتبة؛ لابعادهما عن بعض الأماكن الأخرى»([30]) .
وإذا كان المكان الآخر مكاناً احتمالياً متعدّداً، بالنسبة إلى القارئ ، يتراوح بين قاعة الكتابة، والمطبخ، والخورس، وقاعة النوم، والمستشفى، أدركنا كم تكون مثل هذه العلامة مضلّلة بانفتاحها هذا، خصوصاً بالنسبة إلى قارئها، لا إلى مثيرها الذي قد لا يخطر بباله أنها علامة قد تشكل مادّة للقراءة .
ويبقى التركيز ، بالنسبة إلى العلامات الآنفة ، متمحوراً حول تلك العلامات المفتوحة، بشكل عام، سواء أكانت عديمة المعنى، أم كانت باهتة ، أم كانت متعدّدة الدلالات التي قد تكون متضاربة . يعني أننا أمام علامة غير مستقرّة على دلالة يقينيّة . ويصل الأمر بنا حدّ العماء والتيه حين نقف عند ما تمثله المكتبة ، مكتبة الدير، من علاميّة تحدّث عنها أدسو قائلاً: «بدت لي المكتبة مخيفة أكثر من ذي قبل . فهي إذن مكان لتهامس طويل وسحيق، لحوار لا يُدرك بين رفٍّ ورفٍّ ، هي شيء حيّ ومأوى لقوى لا يقدر الفكر الإنساني على السيطرة عليها . هي كنز أسرار أبدعتها عقول كثيرة»([31]) . لم تعد العلامة التي يتناولها أدسو بالقراءة هذه المرّة ، علامة بسيطة أو طبيعيّة . هي كيان ، فوق نصّي . فإذا كان النصّ ساحة لتزاحم تناصيّ يمثّل حضوراً لتلك النصوص المتزاحمة ، وغياباً لمقاصد الكاتب ، فانّ الكتب ، وبالتالي المكتبة ،هي عرضة لمثل هذا التناصّ، وان كان بدرجة غير عاديّة من التعقيد والتراكب . وهذا ما يؤهّل هذه المكتبة لكي لا تكون علامة إعلان حقيقة ، بقدر ما تصبح علامة على متاهة .
وإعلان أدسو عنها قائلاً: «إذن ليست المكتبة أداة لنشر الحقيقة بل لتأجيل ظهورها»([32]) . إنّما يقدّم لنا وظيفة هذه المكتبة (تأجيل ظهور الحقيقة)وظيفة مختلفة عن وظيفة أيّة مكتبة تذكّرنا بمصطلح (الارجاء) التفكيكي الآنف الذي يبشرنا بأنّ الوصول إلى الحقيقة شيء مستحيل ؛ لأنّ الأرجاء تغييب للمدلول وبعثرة له .
3.5ـ آليّة الشك والتخمين في الرواية: يجرّنا سياق العلاميّة، بشكل إلزاميّ، لنقف عند ثنائيّة: (الشك/التخمين) . وذلك بحثاً عن الآلية التي تحكم قراءة العلامات بالنسبة إلى غوليالمو . ويدفعنا ذلك إلى أن نسأل: علام تقوم هذه الآليّة؟ وهل هي آليّة موصلة إلى اليقينيّة ؟ أو بإمكانها ، على الأقل ، أن توصل إلى شيء من برد اليقين ؟
قال غوليالمو، في أثناء حديثه عن الكيفيّة التي حدس من خلالها بمعرفة دقيقة بالحصان الفالت من الدير: «نحن نستعمل العلامات، وعلامات العلامات فقط عندما تنقصنا الأشياء»([33]) يعني أن اللجوء إلى قراءة العلامات حاجة عمليّة، المقصود منها وضع اليد على حقيقة تتطلب الأمور معرفتها، وان بدت، بالنسبة إلى ما وصل إليه غوليالمو من أوصاف دقيقة للحصان بلغت حدّ معرفة اسمه، رياضة ذهنيّة مجرّدة . وذلك قبل التقائه بالرهبان الذين خرجوا من الدير للبحث عن ذلك الحصان .
ويومئ هذا إلى الهمّ التنظيري الذي يحكم ايكو وهو يسرد ما لا يمكن تنظيره على حد تعبيره، معزّزاً بذلك البعدَ التشويقيَّ الذي يثير المتعة .
ومهما يكن من أمر، فان ايكو، على لسان غوليالمو، قد شفع الحديث عن قراءة العلامات وعلامات العلامات بوصف تلك القراءة (بالتخمين)([34]) . والتخمين وان كان مفارقاً لليقينيّة، بشكل أكيد، فانّه محاولة للامساك بها. ويعني ذلك أن العلامة في تبدّيها الأول لا تقدّم سوى فكرة مطلقة، بعيدة عن الخصوصيّة ، وعلى غاية من الضبابيّة . وقراءة علامات العلامات هي نقلة من الفكرة المطلقة المتصفة بالضبابيّة تجاه التخمين الذي يحتمل التوصيل إلى الدفة اليقينيّة . وما وصل إليه غوليالمو من خصوصيّة تتعلّق بذلك الحصان، فانها لا تُدرك إلا «عن طريق الحدس»([35]) على حدّ تعبيره . فهل الحدس آليّة علميّة موصلة إلى ما هو يقيني ؟ لم يكن غوليالمو نفسه مدركاً إدراكاً واضحاً وكاملاً دقة الأوصاف التي قدّمها . ولو كان مدركاً ذلك الإدراك لما قال: «لم أشف غليلي من المعرفة إلاّ عندما رأيت ذلك الجواد بالذات يقوده الرهبان من لجامه»([36]) . كان تخمينه الصائب مشبعاً بالشّك، وفرحه بنجاح قراءته واللذة التي انتابته نتيجة الفوز بالتخمين، هما تعبير عن انه لو كان متأكّداً من تلك الأوصاف التي قدّمها عن الحصان لكان الأمر عاديّا بسيطا . فشكّه بحقيقة ما قدّره كان مدعاة لإنتاج فرحه، ولذته، وشفاء غليله. والتخمين وغياب اليقينيّة في قراءة العلامات وعلامات العلامات تذكرنا بما جاء في كتاب «الطراز» للبحراني الذي عاش في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، أي قبل زمن الرواية، القرن الرابع عشر الميلادي ، وزمن ايكو، القرن العشرين بأمد طويل . ربط البحراني قبل سوسير العلامة بالمفهوم، رفض قبله مقولة انّ العلامة اسم لمسمى . العلامة ثنائيّة قائمة على (دال/مدلول) . ولقد توصّل إلى ذلك وفق الطريقة التي استخدمها ايكو، حتى لكأنّ ايكو، يردّد كلام البحراني في قوله الآتي: «إن أنت رأيت شيئاً من بعيد، دون أن تعرف ما هو، فستكتفي بتعريفه كجرم ممتدّ . وعندما يقترب منك ستعرف آنذاك أنه حيوان، حتى وان كنت تجهل ان كان جواداً أو حماراً. وعندما يقترب أكثر سيمكنك القول أنه جواد»([37]) . انه المثل نفسه (تقريباً)، ضربه البحراني ليفهمنا انّ العلامة ليست اسماً لمسمى ولكنّها علاقة بين دال مفهوم . اعاده ايكو ، بطريقته ، ومن دون ان يخطر بباله البحراني من قريب او بعيد، ليضعنا في مناخ قراءة العلامات ، وليقول لنا إن القراءة ليست آليّة حاسمة , القراءة تخمين مشوب بالكثير من الشك وغياب اليقينيّة ، فلا تغرب عن بالنا ما جاءت به ما بعد الحداثة من تقويض لسلطة العقل والمنطق .
ولقد شكّلت هذه التخمينيّة الاحتماليّة الآليّة التي اعتمدها غوليالمو في أثناء التحقيق في جرائم القتل التي شهدها الدير . وفي إجابة متشابكة عن سؤال بسيط عمن قتل فينانتسيو ، قال غوليالمو: «من يكون قتله ؟ برينغاريو ؟ قد يكون ملاخي الذي أوكلت إليه حراسة الصرح، أو شخص آخر، يمكن الشكّ في برينغاريو؛ لأنه مرتاع، ولانه يعرف أن فينانتسيو على علم بسرّه . ويمكن الشكّ في ملاخي ، فهو حارس حرم المكتبة . وعندما يكتشف أن أحدهم قد انتهكها يقتله … يورج الكثير من الوقائع تنصح بالارتياب فيه . لماذا لا يكون القاتل بانشيو نفسه ؟… يمكن أن يكون للجريمة دوافع أخرى ولا دخل لها البتة في المكتبة»([38]) . تعقدّت الإجابة ووضعتنا أمام عدد من المتهمين المفترضين: برينغاريو، ملاخي، يورج، بانشيو. أضف إلى ذلك احتمال أن يكون القاتل (شخصا آخر) غير هؤلاء جميعاً . وفرضيات غوليالمو مؤسسة على دوافع متباينة ، علامات مفترضة . ذلك أنّ حضور (قد) التقليليه التي سبقت المضارع الناسخ (يكون) قد يشكّل مرتكزاً إلى علامات احتمالية الدلالة مضلّلة دفعت بالمحقق إلى تيه لا يوجد فيه ما يثبت حقاً أو ينفي حقاً . ويعضد هذا التيه علامة ثانية جاءتنا من افتراض المحقق أن يكون القائل (شخصا آخر) . وإذا كانت كلمة (شخص) نكرة والصفة الملصقة بها(آخر) صفة مفتوحة على احتمالات مجهولة ، فان هذه النتيجة مبنية على علامة افتراضيّة لم تتكشف لعيني المحقق بعد .
ووصل البعد التشكيكي ابعد من هذه الحدود التي قاربت حد الضياع، حين افترض المحقق وجود دوافع لا علاقة لها بالمكتبة . يعني ان غوليالمو يومئ إلى علامات لا يمتلك المحقق أي خيط يرشده إليها. فالدوافع (العلامات) غير معروفة وأصحابها ، بناء على ذلك غير معروفين .
وهذا ما يدفع تيه المحقق إلى أقصاه ، خصوصاً أن العلامة المعتمدة هنا هي علامة باهتة (الدافع إلى القتل مع تعدّد هذه الدوافع). ومهما يكن من أمر، فان مثل هذه العلامات ليست أكثر من لافتات إلى امكانيات افتراضيّة قد تصحّ وقد لا تصحّ؛ مع تعدّد الأشخاص المتهمين واختلاف دوافعهم .
ولفت الانتباه لا يضيء جوهر الحقيقة ، يبقى داخل دائرة التخمين والشك في التعامل مع العلامات . وتأتي إشارة غوليالمو إلى تلميذه أدسو: «هذا يبيّن لك لماذا أحسّ بكلّ ذلك الشك في الحقيقة التي أملكها، حتى ولو أني أؤمن بها»([39]) فلا تقدّم فكرة عن تعاظم الشك «كلّ ذلك الشك» بوصفه آلية حاضرة بقوة في تعامله مع الحقيقة التي يؤمن بها فحسب، ولكنها تفيد ان تلك الآلية الحاضرة مؤسّسة على تجريبيّة متعلّقة بقراءة العلامات، تلك القراءة التي لم توصل ايكو عبر غوليالمو إلى برد اليقين . يعني أنّ منهجيّة الشك المرتكزة إلى منهجيّة التخمين المرتكزة إلى عدم تمحور العلامات حول مركزية محورية ناظمة تستند إليها هي منتجة تلك المنهجيّة القرائيّة .
4.5ـ العقل/القراءة/العلامة: تقودنا ثنائيّة (التخمين) و(الشكّ) إلى أن نتساءل عن دور العقل ومدى حاكميّته في هذه الأمور . هل هو قوّة فاعلة يمكنها انتاج معرفة يقينيّة تقدّم لنا حقائق ، أم أنه فاقد ، بشكل من الأشكال ، مثل هذه السلطة، في رواية «اسم الوردة»، وهو يمكن ان يكون خرافة ، ميتافيزياء عاشت البشرية في ظلّ حاكميتها قروناً من التقدير الخاطئ ؟ واذا اردنا التخفيف من الهجوم التفكيكي عليه، نسأل هل هو هامش يمكن الافادة منه في حدود ضيّقة جداً عند هؤلاء ، وان المدى مفتوح أمام التفتت بعيداً من الناظم وما يمكن ان يتّجه من سرديات كبرى عاشت البشرية ضلالتها في ظلال قرون طويلة .
علّق أدسو على طريقة استاذه غوليالمو في التعامل مع العلامات: بأنه قائم على «مبدأ تجريبي لا يستند إلى المعرفة»([40]) ويعزو ذلك إلى انتمائه الوطنيّ «فأهل بلاده غالباً ما كانوا يعرفون الأشياء بطرق يبدو أن دور العقل النيّر فيها ضعيف جداً»([41]) . وإذا كان رأي أدسو في طريقة استاذه لا يوصلنا بشكل دقيق، إلى أنّ هذا الاستاذ مهملٌ حاكمية العقل، خصوصاً أن التجريب آلية موصلة إلى حقائق علمية يقينيّة ،أضف إلى ذلك أن هذا الاستاذ ينصح تلميذه أدسو قائلاً: «يا عزيزي أدسو، يجب أن تتعلّم كيف تستعمل عقلك للتفكير»([42]). ولئن أشار نصح الاستاذ إلى أن العقل ليس آلة جاهزة للتفكير ، فهي تحتاج إلى دربة، إلاّ أنّ إشارته هذه هي إشارة واضحة إلى دور فاعل للعقل في التفكير والوصول إلى الحقيقة . وهذا الدور الفاعل وان لم يكن دوراً حاسماً، فان له حضوراً يجب ان يؤخذ بالحسبان .
ولئن دلّ كلّ ذلك على مستوى من الثقة بالعقل، إلاّ ان هذه الثقة مدعاة لشروط يجب أن تعضدها لتكون مؤمّلة النتائج . ويذكّرنا هذا ب (كانت) وكتابه «نقد العقل الخالص» الذي يجرّد العقل من امكانية الوصول إلى حقيقة يقينيّة إذا لم تعضده بشروط تؤمّن مسالكه إليها .
ونُصح أوبارتينيو غوليالمو لنجاح عمله التحقيقي: «اسأل الوجوه، ولا تستمع إلى الالسنة» يمثل قاعدة وآليّة لتعرّف الحقيقة . وهذه القاعدة لا تومئ إلى امكانية حضور الكذب على اللسان وفي الكلام، في الوقت الذي لا تقدّم فيه سيماء الوجوه سوى الحقيقة ، بقدر ما تقيم تنافساً بين العلامة السيمائية والعلامة اللغوية . هذا التنافس الذي تتعالى فيه العلامة السيمائية على أختها . وهذا التعالي لا يقف عند حدود لفت انتباه المحقق إلى الأدلّة الماديّة ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى منافسة من نوع آخر . فاذا كانت سيماء الوجه علامة مادية لا تعرف المراوغة فان الكلمات علامات تحمل افكاراً . وتعالي دلالة العلامة المادية على دلالة الكلمة (الفكرة) هو تقليل من أهمية العقل في العمل التحقيقي، والتوغّل في الرواية بحثاً عن موقعيّة العقل في وعي الأمور وفهمها يضعنا أمام موقف محرج . سأل أدسو استاذه بحيرة حول مجادلة يحاول كل طرف من الطرفين فيها إثبات صحة رأيه: «ولكن من كان على صواب ؟، مَنْ الصائب ومن المخطئ ؟»([43]) .
أجابه غوليالمو : «لكل حجته المعقوله، وكلهم اخطأوا»([44]) . الحجة بيّنة تمتلك قدرة اثباتيّة واضحة متخلّصة من أيّ تشكيك في دلالتها ، حسب قواعد العقل والمنطق . ومع ذلك فانّ غوليالمو الذي وصف حجّة كل فريق بانّها معقوله ، أي مقبولة عقلياً ، لم يصل إلى برد اليقين . فجحة كلا الفريقين معقولة والحجتان متناقضتان في ما تسعيان إليه من دلالة . وهذا ما دعاه إلى أن يعلّق على ذلك قائلاً (كلهم أخطأوا) . الحجة المعقولة لم تقدّم حقيقة . كانت على النقيض من ذلك كانت خطأ . وغوليالمو لم يقدّم هذا الاستنتاج ببراءة ، وعفوية. فالأساس الذي بنى عليه خطأ الحجّتين هو أنّ الوقائع الماديّة (العلامات) بمعزل عن العقل . ويعني ذلك انّ الاستنتاج الغوليالموي تعريض بقدرة العقل شئنا ذلك أم أبينا . ونصل إلى النتيجة نفسها عندما رفع غوليالمو عينيه إلى السماء بعد سماعه المقايسة المنطقيّة التي أجراها جيرولامو. وهذا ما دفع أدسو لأن يخمّن أن أستاذه قد «وجد القياس المنطقي الذي أتى به جيرولامو ضعيفاً شيئاً ما»([45]) . والتخمين الذي ساور ظنّ أدسو، وان قلّل من امكانية أن يكون غوليالمو قد رأى ذلك القياس المنطقي ضعيفاً، خصوصاً أن أدسو قد شفع ذلك الكلام بقوله «شيئاً ما»، إلاّ أنه يشير إلى معرفة أدسو بمواقف أستاذه وآرائه المتعلقة بعدم وثوقه بالقياس المنطقي وبالطاقة التي تحكم ذلك القياس (العقل) .
ويصل الأمر إلى موقف حاسم من الحجج المنطقية ودور العقل في سوْقها حين سأل أدسو استاذه «ليست هناك حجج أخرى لاثبات أو لنفي فقر المسيح؟»([46]) «فأجاب غوليالمو: ولكن يمكنك يا عزيزي أدسو أن تؤكّد الأمرين» . وتأكيد أمرين متناقضين بالحجج رفض لأية ثقة بتلك الحجج وشك كبير في دور العقل في تعامله مع تلك الحجج، بما يقودنا إلى فكرة تقويض اللوغومركزيّة، سلطة العقل وحاكميته . وتوصلنا الاستنتاجات المنطقية التي تعامل معها أدسو حول وجود الكتاب إلى ما يشبه العدميّة بهذا الصدد([47]) .
ونجد أنفسنا نبحث بعد هذه الجولة التشكيكية بالعقل داخل الرواية عن حاكميّة أخرى يمكنها أن توصلنا إلى مأمنٍ في التعامل مع العلامات .
أبرزت الرواية، عبر أحد شخصياتها، حاكمية أخرى في مواجهة حاكمية العقل . نصح أوبارتينو غوليالمو لينجح في مهمته التحقيقيّة حول مقتل أدالمو قائلاً: «إذن تجسّس ، نقّب، انظر بعين الفهد نحو ناحيتين : الفسق والغرور»([48]) واذا استغرب أوليالمو مستفهماً «الفسق؟»([49]) ردّ أوباريتنو «نعم الفسق»([50]) . وإذا كان الفسق بالنسبة إلى أوبارتينو، متحكماً بسلوك الكثيرين من رهبان الدير، فان طلبه إلى غوليالمو بالتجسس (تجميع معلومات خاصة)، والنظر بعين الفهد السيّئة الظن ، هو في المحصّلة كلام مفاده : انه إذا كان الفسق آليّة سلوك ، فانه آليّة قراءة علاميّة لاكتشاف الحقيقة .
وإذا نقلنا هذا من حاكمية العقل إلى حاكمية أخلاقية، فلأنّ الطبيعة الانسانية «في تعقّد عملياتها ، توجهنا بحدّ السواء نحو حبّ الخير ونحو حبّ الشرَّ»([51]) .
فهل يعني ذلك أن الطبيعة الإنسانية وبحكم الصدفة التي توجّه الإنسان نحو حب الخير أو حب الشر، هي الآليّة الحاكمة دون العقل ؟ لا تقف الرواية في تفكيكيّتها عند هذا الحدّ فحسب، ولكنها تتجاوزه إلى حاكمية (الشهوة). وحين يرى غوليالمو أنّ بانشيو «ضحيّة شهوة كبيرة»، فهل يعني ان الشهوة هي محركة السلوك وتمثّل آليّة قراءة العلامات ؟ يسترسل غوليالمو في الحديث عن الشهوة: «أما فضول بانشيو فهو تعطّش لا يُروى ، هو صلف الفكر، ووسيلة كغيرها يتخذها الراهب لتحويل رغباته الحسيّة، وهو الحماس الذي يجعل من شخص آخر مقاتلاً من أجل العقيدة، أو من أجل الهرطقة . ليست هناك فقط شهوة الجنس.. وما صدر عن برناردو هو أيضاً شهوة ، شهوة منحرفة للعدالة تتطابق مع شهوة السلطة»([52]). وإذا كانت الشهوة مفتوحة، متعدّدة، غير متناهية، مبعثرة في مناحي متعددة واتجاهات غير محصورة، بما ينفي وجود مركزية محوريّة تضبطها، فانها في المحصلة نفي لمركزيّة العقل ومحوريّته. ويبلغ التشكيك بمحوريّة العقل ومركزيته أقصاه حين يشير غوليالمو إلى انه عندما يتحدث مع أوبارتينو «يبدو له ان الجحيم هو الفردوس منظوراً إليه من الناحية الأخرى»([53]) . ولئن عنى ذلك أمراً، فانه يعني أنّ ماهيّة الأمور وحقيقتها ليست ماهيّة قائمة بذاتها ومستقلة بذاتها تأخذ حقيقتها من الزاوية التي ينظر منها إليها . فهي حقائق بعدد وجهات النظر .
وهذا أقصى التيه الذي يمكن أن يتصوّره الانسان حيال العالم الذي يحيط به. الانسان جرم صغير جداً منفلت في هذا العالم لا يُتاح له ان يضع قدميه على أيّة أرض صلبة .
كيف لا ، واذا كانت الشهوة هي آلية السلوك ومنتجة العلامات والحاكمية المؤهلة لقراءة ذلك السلوك وتلك العلامات، فما جدوى القراءة اذا ؟
ويجرنا هذا إلى تعرّف امرٍ يتعلق بسيمائية ايكو هو غياب المحور الناظم .
5 .5 _غياب المحور الناظم في سيمائية ايكو:
تركت منهجيّة غوليالمو (إيكو) في التعامل مع فكرة وعي العالم بصماتها الواضحة في وعي تلميذه أدسو . فهو حين وصف كتابة تجربته تلك روايةً ، خاطب قارئه قائلاً: «ما وعدتك أنا برسمٍ متكامل وإنما بسلسلة من الأحداث المدهشة الرهيبة»([54]) .
فهو لم يع بنية لحصيلة تجربته تلك ، ولذلك فان ما سيقدّمه لقارئه من تلك التجربة سلسلة من الأحداث . وهو وان وصفها بالسلسلة بما يوحي بشيء من التماسك، إلا أنه لم يصف تلك السلسلة بالبنية . فهل يشير بذلك إلى أن حصيلة المعرفة البشريّة هي معرفة بجزئيات مبعثرة لا ينظمها ناظم ؟ ولذلك رأيناه يخاطب قصّته التي يكتبها قائلاً: «استمري ايتها القصّة . فهذا الراهب الشيخ يطيل التوقف عند التفاصيل الهامشيّة»([55]) .
وإذا عنى بالراهب الشيخ نفسه، فان الإشارة تعني ان ما حصّله هو من وعي ومعرفة بالعالم هو نتاج تجربة العمر كله . وكأنه يوحي إلى القارئ بالافادة من هذه التجربة المعرفيّة فلا يطمع بالحصول على قواعد عامة ضابطة ، وان يصف التفاصيل التي يتوقف عندها في روايته بالهامشية، انما يفسّر لنا حقيقة قصده بالسلسلة .
فالسلسلة تتابع لا ترابط ؛لأنّ الهامشيّ يقف في الموقع الضدي من الكليّ، أو هو نفي له ولوجوده . فلو كان موجوداً، لماذا يهمله أدسو ؟ ولم تتركنا الرواية عند هذا الحد ولكنها أقامت جدلاً نظرياً حول ثنائيّة (السرديات الصغرى / السرديات الكبرى) . فعندما قدّر ادسو، ذات لحظة، «ان كتاب الطبيعة يحدّث فقط عن جوهر الأشياء»([56]) .
اجابه غوليالمو على الفور «ليس الأمر كذلك تماماً»([57]) .
ولئن أمّلتنا طريقة غوليالمو بالرّد بإمكانيّة ان تتحدث الطبيعة عن جوهر الاشياء، إلاّ أنّ هذا الأمل هو أمل ضعيف وغير واثق من نفسه. فنفي هذا الأمر (ليس كذلك تماماً) يجعل السلبي متعالياً على الايجابي في هذا الكلام، وان لم ينفه تماماً.. خصوصاً أن غوليالمو يرى ان «الحدث الذي يقع مرّة أو يتكرّر حدوثه لا يفضي بالضرورة إلى قاعدة عامة»([58]) .
واذا منّتنا كلمة (بالضرورة) بشيء من الايجابيّة فان نفي الافضاء إلى قاعدة عامة يجعل من تلك الأمنية أمنية قائمة على قاعدة (تفاءلوا بالخير) وان كان التفاؤل غير مفضٍ بشكل حتمي ، الى الحصول على الخير . والدرس الذي تعلمه ادسو من استاذه من انه «يتحدث بكثير من التحفظ ، عن الأفكار المطلقة ، وباحترام كبير عن الاشياء الخصوصية»([59]) ، انما هو إشارة إلى سريرة الاستاذ التي يتسم موقفها بالسلبية من (الافكار المطلقة) السرديات الكبرى . فالتحفظ والتحفظ الكثير غير مشجع على القبول ، بل هو مدعاة لرفضها، خصوصاً أنّه عندما يتحدث عن الأشياء الخصوصية (السرديات الصغرى) باحترام كبير يوحي الينا بقبولها . وان كان هذا القبول لا يعني ان غوليالمو مسرور بهذا الموقف . يقول: «في الوقت الذي أشكّ فيه كفيلسوف، ان للعالم نظاماً ، اتعزّى، حتى ان لم اكتشف نظاماً، فعلى الاقل، باستنباط سلسلة من العلاقات بمقادير صغيرة بين قضايا العالم»([60]). يعي غوليالمو غياب نظام للعالم ، ويعي أنه يعي ذلك .
وهذا الوعي هو وعي مؤلم. والفعل المُسند إلى المتكلّم (اتعزّى) إشارة إلى أمل قد يتحقّق وقد لا يتحقّق . ومع ذلك فان هذا الأمل يعزّيه. والتعزية تعني أنّ غوليالمو مؤمن بان الانسان محاصر بالعدميّة . وهو انسان مقهور مغلوب على أمره، ضائع . وهو مع كل ذلك ساع إلى اكتشاف أنضاء نظام، سلسلة من العلاقات بمقادير صغيرة بين قضايا العالم .
فهل يبلغ هذا الأمل، بموقف غوليالمو (ايكو) أبعد من التشكيك بوجود نظام (سرديات كبرى) ليظلّ فريسة السرديات الصغرى؟ . يرى غوليالمو : انه «من الصعب ان يقبل الإنسان فكرة انعدام وجود نظام في الكون»([61]) .
6ـ رواية «اسم الوردة»: التاريخ والوظيفة
لا يمثل إعلان ايكو «كنت قروسطيا في حال سبات» اعترافاً بصفة سلبيّة ، قصد التحرّر منها . الاعتراف مرتكز عنده الى فلسفة يؤمن بها. التفكيكيّة التي ترى في كل حضور غياباً ؛ لأنه يقوم على سلسلة من الطبقات الرسوبيّة . والطبقات الرسوبيّة ليست بنية فيها من التماسك ما يعطيها هويّة خاصّة . هي طبقات قابلة للتفكيك ثم العزل طبقة طبقة، وصولاً إلى الغياب . كيف لا وهو يقول: «كنت أرى تلك الحقبة (القرون الوسطى) أينما وجهت نظري»([62]) . وهو بوصفه ما بعد حداثي تفكيكي يرى «ان الماضي ما دام لا يمكن تدميره واقعيّاً ، لأن تدميره يفضي إلى الصمت يجب ان يُستزار من جديد ، ولكن بشيء من السخرية ، ودون براءة»([63]) .
فهل يقصد من ذلك بانه يجب الا نزيل الطبقات التاريخية المترسبة طبقة طبقة؛ لان في ذلك تدميراً لذلك الماضي وتدميره مفضٍ إلى تدمير الحاضر ، فيخرج بذلك، وفي هذه النقطة بالذات، على المنهج التفكيكي الذي يرفع شعار المعول التقويضي، فاستعاض بالتقويض زيارة ذلك الماضي . تلك الزيارة المشفوعة ، حسب ايكو، بأمرين : السخرية وعدم البراءة .
ترك ايكو السخرية معلّقة بالهواء بعيداً عن تعديتها الى مثير السخرية، بما يترك ذلك المثير، مثيراً مفتوحاً على تعدديّة احتماليّة غير محصورة . فما سبب تلك السخرية ؟ وجود مفارقات ؟ وجود غباء ؟ أم لماذا ؟ وهو كما ترك السخرية مفتوحة ترك غياب البراءة مفتوحة أيضاً . ما طبيعة الحصافة التي نتّصف بها في أثناء زيارة الماضي ؟ هل هي الميزان النقدي العقلي ، التاريخي التطوريّ ؟ وعلى أيّ نظام يرتكز عدم البراءة حيث لا نظام في التفكيكية ؟
يدخل ايكو هنا مدخلاً شبيهاً بمدخل التناص الذي يعتري أيّ نصّ جديد . فالنصّ منظور اليه تفكيكياً، هو نص معيد «لنصوص أخرى معروفة ولكنها تُقرأ داخل شبكة جديدة من العلاقات»([64]) ولا يختلف التاريخ الحاضر عن النص الحاضر فهو معيد لتواريخ أخرى معروفة ، ولكنها تقرأ داخل شبكة جديدة من العلاقات ؟ فما أهميّة هذه القراءة وما جدواها ؟ يرى ايكو اننا لا نستعمل التاريخ لقراءة تاريخية بل «لقراءة تأويلية تربط الماضي بالحاضر»([65]) .
ويبقى السؤال ما جدوى هذا التأويل وعلام يقوم ؟ هل يشفي الغليل ؟ ان التأويل مفضٍ إلى معرفة بوضعية الانسان الحاليّة. هذه المعرفة التي تمكنه من حياة افضل ، وان كانت هذه الحياة محاصرة بالماضي في حركتها وفي كيفيّة تشكّلها .
ولعل العودة الى الماضي بشيء من السخرية من قبل ايكو يظهر في قوله: «نشأت رواية (اسم الوردة) من فكرة استحوذت عليَّ وانا في الثانية والعشرين من عمري، عندما ابتعدت نهائياً عن الكنيسة، حيث كنت أناضل في الحركة الكاثوليكية : كان بودي أن أقتل راهباً»([66]) . حتى لكأن الرواية تعويض لرغبة مكبوتة، وفق النظرة الفرويدية .
والفرويدية وان اتخذت لنفسها صفة العلم في ظل حركة الحداثة، إلاّ انها تفسّر سلوك الانسان بمعزل عن أي نظام أو قاعدة ثقافية أو تربوية او اجتماعية .
يتمحور هذا التفسير حول الذات والطفولة والصدفة . فالفرويدية ، في المحصلة ، مهاد لما بعد الحداثة أو هي تفكيكية بشكل من الأشكال . ولا يبعد ان تتلاقى ما بعد الحداثة مع الفرويدية عند ايكو . والتاريخ هنا ، مقتل الرهبان في ذلك الدير المنعزل في الجبال ، لا يحمل بعداً تعويضيّاً كما خلص إليه المترجم([67]) ، بقدر ما هي إشارة إلى ان الفساد الذي عمرت به حياة الرهبان في القرن الرابع عشر ما زال قائماً في حياة رهبان القرن العشرين، بما يعيدنا إلى التفكيكية التي ترى الحاضر غيابا والماضي حضوراً .
ويبقى مع كل ذلك أن نعود الى مقولة ايكو «ما لا يمكن تنظيره ينبغي سرده» . فهل يعني ذلك أن الرواية بامكانها أن تعوَّض عجز النظرية اذا عجزت ؟ يتبادل النصّ النظري والنص الابداعي ، كما نعرف، المنافع ؛ يفيد كلّ منهما من تجربة الأخر من دون انقطاع على مدى التاريخ . فلا نظرية من دون موضوع ، اللغة مثلاً، تقوم النظرية بناء عليه . والموضوع لا يمكنه ان يتطوّر بوتيرة جيّدة وعملية من دون النظرية التي تتناوله .هذا ما يفترضه العقل الحداثي . أما ونحن أمام التفكيكية مع ايكو، فالنظرية والرواية ، قابلتان لتبادل الأدوار انطلاقاً من قاعدة التناصّ في المجالين النظري والاجرائي . فالنظرية والرواية كلاهما حضور للماضي نفسه . وحين تُعيي الحيلةُ احدَهما يتنطح الأخر للقيام بالوظيفة نفسها . ولعل حياة ايكو الثقافية التي بدأت بالتنظير ، ثم انتقلت إلى السرد (1980) عبر «اسم الوردة» تمثل مصداقاً لهذه النقلة . ويقودنا كل هذا لنثير سؤالاً مبدئيّاً ، من خارج دائرة التفكيكيّة ، اذا قام التنظير على التفكير والأفكار المجرّدة إلى حد بعيد والخطاب الأدبي على أسلوبية جمالية محمولة على أكف السيمائيّة ، فهل يحافظ الخطاب الأدبي على أدبيّة لافتة ممتعة اذا مثّل امتداداً للدرس النظري ؟ وهل تمثّل نقلة ايكو هذه «ما لا يمكن تنظيره ينبغي سرده» دعوة إلى أدبيّة مختلفة جديدة، تفرضها ما بعد الحداثة ؟ إن تجربة الخليل بن احمد الشعرية ، تجربة المنظِّر الاساسي للأيقاعيّة الشعريّة في التاريخ الأدبي القديم، أهملها التاريخ الأدبي ، لأنها لم تتملّك الشعرية الاسلوبية السيمائية. ومقابل ذلك، فان تجربة سارتر في «دروب الحرية» وتجربة كامو في «الغريب» لم تصمدا؛ لأنهما نتاج منظّرَيْن كبيرين للفلسسفة الوجودية ، صمدتا لأدبيتهما المؤسسة على رؤية هذين الفيلسوفين الى العالم ، ولم يكونا امتداداً تنظيرياً لما ذهب إليه الفيلسوفان الوجوديان . ونعود إلى السؤال الكبير نفسه .
لماذا أوصلنا ايكو في «اسم الوردة» إلى ان نتحسس قدراتنا القرائيّة ونحن نقبل على التعامل القرائيّ معها ؟ ولماذا تدعونا إلى استحضار نظريات متعدّدة لنتمكّن من تلك القراءة؟ هل يدعو إلى متعة قرائية صعبة المنال لا يستطيع الحصول عليها إلاّ أولو العزم والثقافة العالية من القرّاء ؟ يجرّنا هذا إلى سؤال مبدئي : هل كانت «اسم الوردة» منتمية إلى الرواية ما بعد الحداثيّة حقاً . عُرفت الرواية ما بعد الحداثيّة «بالرواية الجديدة»، التي تقوم على جرّ القارئ إلى مسارات متعدّدة حتى إذا احسّ القارئ في مسار من هذه المسارات بانه قد أمسك برأس خيط الرواية ، وأنه قد امتلك القدرة على متابعتها برفق وسلام ، دفعته إلى متاهة تجعله يبحث من جديد عن رأس خيط جديد ، وهكذا دواليك .
«اسم الوردة» ليست رواية ما بعد حداثيّة ، بناء على هذه القاعدة ، لأنّ سياقها متصل ، مع تشعّب دروبها . وهي في المحصّلة لم تصل بالقارئ إلى تضييع السببيّة النظامية التي أودت بحياة قتلى الدير ، وصلت به إلى فهم مقنع لما جرى .
أضاعت الرواية الكتاب الذي كان هاجس معظم شخصياتها ومدار تفكيرهم ، ومواقفهم ، وسلوكهم ، هذا الضياع الذي اضطر ايكو، لكي يبرز ،بقسوة،عبثيّة البحث عن ذلك الكتاب، وعدم أهميّتها ، إلى أن يدمّر الدير تدميراً كاملاً ، وتحويله إلى اطلال . وهذا ما يجعلنا نفكّر «برباعيّات الخيام» التي قامت رواية «سمرقند» لأمين معلوف حولها بشكل أساسي . وكانت «الرباعيّات» مدار تفكير الشخصيات الأساسية في الرواية ومواقفهم وسلوكهم . واذا ادى الحريق في «اسم الوردة» إلى تضييع الكتاب وتضييع الجهود التي بُذِلت للحصول عليه متّهما النار ، فان الغرق قد أدى في «سمرقند» أمين معلوف إلى النتيجة نفسها،اتّهام الماء هذه المرّة . ولئن كانت رواية «سمرقند» رواية جميلة تستدعي القراءة في كل الأحوال ، إلاّ أنها تفقد الكثير من بريقها عند من يقرأ رواية «اسم الوردة» لايكو ، ويفكّر بأناة في حسبان أمين معلوف ، هو الآخر ، تفكيكياً . ومن يطبّع العلاقة مع درّيدا فإنّه سيطبّع حكما العلاقة مع الجماعة التي ينتمي إليها درّيدا ، الكيان الإسرائيلي .
ومهما يكن من أمر فان «اسم الوردة» وان قامت على سياق متصل لا يأخذ القارئ إلى متاهات، مع وعورة مسالكها وصعوبة السير فيها، إلاّ انها عامرة بمناخات ما بعد الحداثة التي تمثّل الحضور الأقوى . هذا الحضور الذي انتقل بعلمٍ حداثيّ هو السميولوجيا .. ليكون مطواعاً لمقولات ما بعد الحداثة. يسوّغها ويجعلها متعالية على مقولات الحداثة في هذه الرواية .
ومهما يكن من أمر ، فانه يمكننا ان نمثّل ما بعد الحداثة وطبقاتها الرسوبيّة القابلة للتفكيك والعزل ب(النملة) التي تجمع في خزائنها الأرضيّة، مؤونة قابلة للتفكيك والعزل . أمّا الحداثة فتتمثّل ب(النحلة) . واذا غابت شخصيّة النملة عمّا جمعته من مؤونة ، فانّ شخصيّة النحلة لا يمكن عزلها عما صنعته من عسل .
هذا العسل الذي لا يمكن تفكيكية وعزل مكوّناته؛ لانّ تلك المكونات لم تبق كما هي أصابها التحوّل . هذا التحوّل الذي يمثل حضوراً لشخصية النحلة وفيه يكمن إبداعها .
([3]) ماريو نوسكو، حوار مع ايكو، متاهات البرتوايكو، ص 80 .
([14]) ص 36 . 2_ derrida carte postale p88 3_زيما ، التفكيكيّة ، ص 75 .
 الملتقى الثقافي الجامعي
الملتقى الثقافي الجامعي